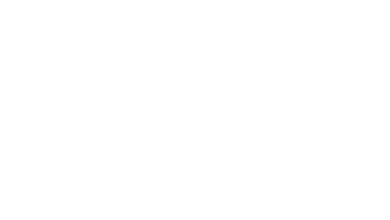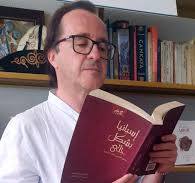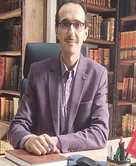الإشكاليات التطبيقية للإجماع(حمادي دويب)_2_
وهناك مشكل تطبيقي آخر تطرق إليه الدارسون المعاصرون للإجماع يتمثل في طبيعة الإجماع. فحتى ينعقد الإجماع ينبغي أن يتأسس على قول أو على فعل وأن يكون كل المجتهدين قد استشيروا وأن يعبروا جميعا عن آرائهم لكن الإشكال أن النظرية السنية حول الإجماع لا تقدم آلية ولا تقترح مجلسا أو تنظيما محددا يسمح للمجتهدين بالإجماع أو على الأقل يضطلع باستقبال كل الآراء. ويعد طابع عدم تنظيم الإجماع وغياب سلطة ترعاه من أهم الأفكار التي انتقدت الإجماع في مستواه التطبيقي[1].
وإذا كانت مشاركة كل المجتهدين شرطا فلأن الإجماع لا يمكن أن ينعقد حسب النظرية المهيمنة إلا إذا كان هناك إجماع مطلق. فأغلبية الأصوليين يرون أنه إذا عارض الإجماع مجتهد واحد فالإجماع لا يصير حجة لكن ما موقف المحدثين من هذه الكلية ؟
لم يجار المحدثون عموما هذا الرأي لوعيهم أن الإجماع الكلي ليس عمليا[2] وأنه يستحيل تطبيق هذا التعريف التقليدي للإجماع[3] وقد تساءل بعضهم إن كان الواقع كرّس هذه الكلية التي نظر بها الأصوليون ليمنحوا الإجماع تبريرا كافيا للوجود كما تساءلوا ألم يكن التفكير الأصولي يستشعر الخوف من تشريك جميع المسلمين على اختلاف مستوياتهم الثقافية وانتماءاتهم السياسية في صياغة الإجماع ؟ أي هل يمكن أن تقبل المؤسسة الدينية الصارمة بمساهمة العامة في استقطاب الأحكام انطلاقا من القرآن والسنة[4].
وتثير طبيعة الإجماع مشكلا آخر : هل الإجماع السكوتي شرعي ؟ وهل المجتهد الذي لزم موقف الصمت مشارك في الإجماع ومؤيد له أم لا ؟
يثير الباحثون المحدثون هنا من جديد الموقف الحنفي الذي منح الدعم القوي لمفهوم الإجماع السكوتي، وقد استعادوا الاعتراض القديم على هذا النوع من أنواع الإجماع وهو أن السكوت قد يكون وليد التقية والخوف ويقع الاحتجاج في هذا السياق بابن عباس الذي لم يتجرأ في حياة عمر على معارضته فيما ذهب إليه في مسألة من مسائل الميراث (العول)[5].
كما أثار الباحثون المعاصرون موضوع الإجماع أو المجمع عليه فتساءلوا عن المجالات التي يكون انعقاد الإجماع فيها معصوما في نظر الأصوليين، وهل تشمل هذه المجالات الجانب الديني والدنيوي والكلامي والفقهي والسياسي ؟ وقد استخلصوا وجود تيارين الأول يمثل عددا قليلا من الأصوليين[6] يوسع مجال تطبيق الإجماع المعصوم إلى كل المجالات التشريعية واللغوية والعقلية والدنيوية. أما تيار الأغلبية فإنه يضيق مجال الإجماع. وفي هذا السياق برّر بعض الأصوليين إخراج المسائل الدنيوية من الإجماع بعمل الرسول الذي كان يرجع إلى الأمة في الأمور الدنيوية فإذا لم يكن هو معصوما في هذه المسائل فالأمة أكثر عرضة للخأ منه[7].
والملاحظ أيضا أن أغلب الأصوليين يستثنون من الإجماع أيضا المسائل الاعتقادية وهكذا فإن المجال الوحيد الخاص بالإجماع حسب أكثر الأصوليين هو الشرع، لكن ذلك لا يعني أن كل قواعد الشرع يمكن أن ينظر فيها الإجماع، فالإجماع مثلا لا يمكن أن يعارض نصا قطعيا صريحا واضحا.
هذا الوضع الذي يهمش المسائل الدنيوية من مجال نظر الإجماع لم يجاره الكثير من الباحثين المعاصرين ومنهم من لا يرفض مشروعية الإجماع.
وفي هذا السياق حاول أحد الباحثين[8] أن يقارب مفهوم الإجماع من خلال مسائل دنيوية نظر فيها بعض المفكرين والأدباء في فترة ما بين الحربين وفي مصر على وجه الخصوص من ذلك أن مصطفى صادق الرافعي (ت. 1937) في معالجته لمشكل اللغة العربية يضع المسألة في إطار ديني مستخدما إجماع المسلمين لتأكيد إعجاز اللغة العربية وفصاحتها وبهذا يواجه المجددين.
أما طه حسين (ت. 1973 م) فلئن كان يحترم الإجماع اللغوي للقدامى مع تأكيد حق المعارضين في الاجتهاد لأن العربية لغتهم مثلما هي لغتنا فإنه في المقابل لا يعترف بأي سلطة للإجماع الأدبي لأجيال عدة وخلال قرون كثيرة وهذا ما عبر عنه خاصة في كتابه “الشعر الجاهلي”.
ومن جهة أخرى اعتمد حسين هيكل في كتابه “حياة محمد” على الأحداث التاريخية التي حظيت بإجماع المؤرخين وهو يستدعي سلطة الإجماع لحل المشاكل العسيرة مثل الغرانيق أو زواج الرسول من زينب أو خصومته مع زوجاته. وهكذا فالإجماع الذي يتطرق إليه هيكل هو إجماع دنيوي مستلهم من الغزالي.
كما ركز بعض الباحثين على أن الإجماع يمكن أن ينظر إليه في عصرنا باعتباره متطابقا مع الرأي العام، وعلى هذا الأساس نظروا في بعض المسائل الدنيوية التي كان للرأي العام فيها موقف محدد من ذلك وقوع حادث مشهود في القرن السابع عشر للميلاد برهن على وهن إجماع الفقها،ء أما ضغط الرأي العام حتى ولو استند هذا الإجماع إلى السلطة الزمنية.
فحين بدأت عادة احتساء القهوة تشيع في بلاد الشرق أصدر الفقهاء فتاويهم في شبه إجماع على أن احتساء القهوة محرم ويعاقب شاربها كما يعاقب شارب الخمر وقد نفذ حكم الإعدام ضد بعض الذين أقدموا على عصيان هذا الأمر. لكن إرادة المجموعة هي التي انتصرت وأصبح علماء الدين أنفسهم يحتسون القهوة[9].
واستيحاء لنفس هذا التصور اعتبر بعض الباحثين أن إصلاح مجلة الأحوال الشخصية في تونس بين سنتي 1956 و1957 قد حظي بإجماع الأمة أي الشعب التونسي لأنه أمر دنيوي[10] لكن حين تعلق الأمر بتغيير يمس أمرا دينيا لم يوافق الرأي العام وهكذا لم يحدث الإجماع[11].
وإذن فإن هذا التيار من الباحثين يرون إمكانية قيام إجماع معاصر يفرض نفسه داخل الأطر الوطنية وأن هذا الإجماع المحلي يهيء لإجماع عام[12].
ويبدو أن الطابع المحلي والوطني للإجماع فكرة تولدت عن وعي المعاصرين باستحالة تطبيق مفهوم إجماع الأمة كلها في ظل واقع معاصر يتسم بانقسام الأمة إلى أقطار وشعوب متنوعة التقاليد مختلفة الخصائص ، يقول أحد الباحثين السلفيين في هذا المجال : يصح أن يعقد الإجماع السابق المواصفات أهل كل وطن ينظرون ما عليه حالهم ويجمعون على أمر من الأمور يخص معاشهم وعمرانهم وذلك لوقوع التمايز والتخصص في الجزئي من أمور الناس تبعا لخصوصيات كل دولة، ومرد ذلك أن القرن العشرين أوجد في الأمة الإسلامية معطيات عصرية في السياسة والعلوم والكسب والبنى الثقافية جعلت منها شعوبا وأوطانا وقوميات وطبقات ومذاهب ومدنا متعددة منتشرة مختلفة الخصوصيات والتمايزات[13].
لكن في مقابل هذه الرؤية نجد بعض الباحثين ينطلقون من المشاكل التطبيقية التي يثيرها مبدأ الإجماع ليبرزوا أن الاختلاف والتردد من أهم خصائص أجوبة الأصوليين على هذه المشاكل وهذا التيار يرى أن الإجماع انعقاده مستحيل، وهي نتيجة تستخلص من ملاحظة الإسلام في مستواه التطبيقي الواقعي. فالإسلام في نظرهم ليس القرآن وسنة النبي وفكر الفقهاء والمتكلمين فحسب بل هو أيضا الواقع والناس : أشواقهم ومعاناتهم وأفراحهم وأعيادهم وطقوسهم.
إن إلقاء نظرة على هذا الواقع يستخلص منه تنوع عظيم يجعل إمكانية انعقاد الإجماع أمرا مستحيلا[14].
ويبدو أن هذا الموقف متأثر بنتائج بعض البحوث الأنتروبولوجية حول الإسلام من ذلك تجربة عالم الأنتروبولوجيا ميكائيل قيلسنان (Michael Gilsenan) فقد أخذ في اكتشاف الإسلام بدراسته على عين المكان في اليمن ومصر ولبنان ثم درسه عن طريق التاريخ وتقارير الأنتروبولوجيين الآخرين. وصرح في الأخير أن له انطباعا إنه في متاهة أو في حديقة برية وإنه يسير دون هدف ودون إدراك غاية ما. وإن عظمة الإسلام غير قابلة للإدراك[15] إضافة إلى ذلك يلاحظ تعايش مذاهب إسلامية متنوعة في صلب الأمة من أهل سنة وشيعة وغيرهم واختلاف الممارسة الدينية والمواقف الدينية الأساسية داخل هذه المذاهب ذاتها ووجود هوة بين تصوّر الإسلام عند الفقهاء وتصور الصوفية له وتعدد الأنظمة السياسية الإسلامية وتنوعها وتطبيق الشريعة الإسلامية قد يلغي بفعل أهمية العادات والأعراف المحلية (من ذلك أن القوانين القرآنية الخاصة بالميراث لا تطبق في أندونيسيا بسبب سلطة العادات) ويستنتج من كل هذا غياب إجماع نظري في مستوى رسمي ونقص ظاهر في الوحدة ووجود تناقضات تميز البنية الداخلية للإسلام.
ومن أهم المشاكل التطبيقية التي تطرق إليها الباحثون المعاصرون مشكلة فاعلية الإجماع ومدى سلطته في علاقته بالأصول التشريعية الأخرى وبإجماع السلف. فقد اعتبرت النظرية السنية أنه لا يمكن للإجماع أن يكون ناسخا للقرآن والسنة المتواترة أو منسوخا من إجماع آخر[16].
والإجماع بدوره حجة قطعية، لذلك لا يمكن أن ينسخه إجماع آخر اعتمادا على قاعدة “إجماع أهل كل عصر حجة على من بعدهم”[17] وبهذه القاعدة تدعم سلطة الماضي –التاريخي أو المتمثل فحسب- بحيث لا يتسنى مخالفة إجماع الصحابة والمتقدمين عموما سواء في عملهم أو في تأويلهم للنصوص[18].
وقد انتقد الباحثون المعاصرون بشدة موقف منع نسخ إجماع لاحق لإجماع سابق ولاحظوا أن ما ترتب عنه هو جمود الفكر الإسلامي والانسياق إلى التقليد[19].
وبين باحثون آخرون أن الإجماع الجديد ربما “يبني حكمه على دليل غفلت الأمة عنه تبعا لاختلاف العصور وتوسع مصالح الناس وتصور قدرات الاجتهاد ومناهجه”[20]. وهذا الموقف تأسس على فهم جديد لعصمة الأمة فلا يوجد في الشريعة تصريح يجعل عصمة جيل من الأجيال تحكم كل الأجيال اللاحقة، وهكذا فالعصمة في الجيل والعصر وليس في كل العصور، لأنه ينافي الشريعة ويحجر الرأي، إذ لا يمكن أن يجتمع قوم قبل ألف سنة ويقرروا في مسألة جزئية نجبر جماعة أخرى عليها بعد ألف سنة فنقيدهم[21].
والملاحظ أن هذه الأفكار تجد جذورها في اجتهادات ممثلي الحركة الإصلاحية الإسلامية، إذ أن محمد عبده كان من المؤيدين لفكرة نسخ إجماع لاحق لإجماع سابق، إذا لم يكن ممكن التطبيق في ظل الظروف الطارئة[22]. والمقصود طبعا المسائل الدنيوية وهذا ما أكد عليه رشيد رضا ومروان احتفظ بالموقف التقليدي إزاء المسائل الدينية فإنه في الأمور الدنيوية شرع إعادة النظر في الإجماع السابق وإمكانية التراجع فيه. إلا أن هذا التراجع لا يمس إجماعا عاما مستندا إلى نص قطعي لم يطعن فيه أبدا نص آخر وقبله الجيل الأول بإجماع. وإنما يمس قرارات الصحابة غير المجمع عليها، أو حلول المدارس الفقهية إن كان مختلفا فيها وهكذا فخارج إجماع الجيل الأول من المسلمين، جيل الصحابة ليس للإجماع سوى طابع ظرفي.
وهذا الموقف في نظر بعض الباحثين مهم لأنه يعطي للمسلم هامشا من الحرية يتقابل والمحافظة التي تنجر عن إجماع لا يمكن التراجع فيه. كما أنه مهم لأنه يحدث قطيعة بين الديني والدنيوي في منظومة كانت تمزج المجالين. وقد عدّ هذا العمل أقرب إلى طريقة التفكير الغربية منه إلى رؤية الفقهاء المسلمين التقليديين[23].
إذن نستنتج أن الباحثين المعاصرين تطرقوا إلى المشاكل التطبيقية التي يثيرها مبدأ الإجماع من خلفيات ومنطلقات متنوعة ومتباينة أحيانا، وهم على اختلاف مشاربهم يدركون أن النظر في الإجماع لدى الأصوليين القدامى لم يؤد إلى تقديم مقترحات عملية، ولذلك رأى بعض الباحثين أن النظرية التقليدية تقبل مبدأ الإجماع نظريا، لكنها تحدّ من إمكانية تطبيقه عن طريق وضع شروط لا يمكن تحقيقها. وعلى هذا الأساس اعتبر البعض أن الإجماع دون تطبيق ليس له إلا وجود رمزي[24] في حين سعى آخرون إلى تقديم مقترحات وحلول متأثرة بالعصر ومستلهمة من نظمه ومكتسباته، من ذلك ما اقترحه رشيد رضا من إنشاء مجلس من العلماء ورجال السياسة من ذوي المناصب المرموقة يتخذون قراراتهم باعتماد ثلثي الأصوات[25].
واقترح آخرون إيجاد مجمع فقهي يضم جميع الفقهاء في العالم الإسلامي يكون له مكان معين ويجتمع في أوقات محددة ودورية تعرض عليه المسائل الجديدة للنظر فيها وإيجاد الأحكام لها في ضوء نصوص الشريعة وقواعدها ومبادئها العامة[26] كما رأى البعض أنه ليس صعبا أن يجتمع المجتهدون سنويا أو كلما دعت الحاجة في أي قطر إسلامي أو في مكة في موسم الحج لتدارس المشاكل الجديدة[27].
لقد سعينا لإلقاء بعض الأضواء على المجهود النقدي الذي اضطلع به الباحثون المحدثون إزاء المصدر الثالث في التشريع الإسلامي وهو الإجماع.
وحاولنا في هذا المجال أن نشير إلى تطور الدراسات النقدية الخاصة بالإجماع خلال النصف الثاني من القرن العشرين على وجه الخصوص، وهذا التطور لا يهمنا منه الجانب الكمي بل الجانب النوعي ذلك أن العدد القليل من الدراسات الجادة التي تعتمد مقاربات حديثة هو عامل من عوامل إثراء النظرة إلى الإجماع وتغييرها وتوجيهها نحو آفاق وسبل لم تكن معروفة من قبل.
كما قمنا بالنظر في البراهين التي تؤسس الإجماع نظريا ونقد المحدثين لها وأردفنا ذلك بالتطرق إلى المشاكل التطبيقية التي يثيرها مبدأ الإجماع.
ولعل المطلع على هذا النقد يتساءل عن الأسباب الكامنة وراء هذه المواقف الناقدة وقد حاول بعض الباحثين الإجابة عن هذا التساؤل بالقول أن حجج تأصيل الإجماع غلفت بالبداهة عبر القرون وكأنها حقائق مطلقة لذلك من حق المحدثين إعادة النظر فيها. ويرى هؤلاء أنه يوجد سببان قويان لتغيير قرارات السابقين أولهما تطور الفهم عبر التجربة والاعتبار من الأخطاء أما السبب الثاني فهو التغير المستمر في الظروف التاريخية وهو ما يجعل بعض القواعد الصالحة في الماضي لا تصلح للحاضر[28].
ورأى باحثون آخرون أن العوامل الاجتماعية الجديدة والظروف الاقتصادية الجديدة يمكن أن تحمل الإسلام على طرح تساؤلات جديدة وإعادة صياغة إشكالياته الأصلية وحلها بشكل مستحدث.
[1] – راجع Camille Mansour, l’Autorité, ، المرجع المذكور ص 100.
[2] – محمد شحرور، الكتاب والقرآن، قراءة معاصرة، ص 582.
[3] – رفيق العجم، الأصول الإسلامية، المرجع المذكور، ص ص 129-130.
[4] – عبد المجيد الشرفي، الإسلام والحداثة، المرجع المذكور، ص 165.
[5] – انظر : Dominique Urvoy : Les Arabes et la critique historique, Horizons Maghrébins, n° 25/26-1994 p. 51.
[6] – يقول سيد أحمد خان : “في مجرى 1250 عاما لم يقم أحد حقا بالمحاولة التي نقودها وأنا لا أرتاب في أنني سأتهم بخرق إجماع الأمة بيد أن من النظريات الدينية المعتبرة أن الإجماع الجديد يمكن أن ينقض الإجماع القديم. ولن يصل أحد إلى الإجماع الجديد إلا عن طريق خرق الإجماع. وإذن فلا ينبغي لأحد أن تأخذه الدهشة إذا كنت أنا أول من يظهر معترضا سبيل الإجماع الأول وقائما على رأس أولئك الذين سيؤسسون ذات يوم الإجماع الجديد الذي ينقض الإجماع السابق… أيها الأخوة المسلمون إن ما تحملونه في صدوركم من تصورات دينية هو نتيجة ضيق الأفق في معارفكم ولكن وقت هذا الضيق الفكري قد ولى وانقضى ونحن نعيش في زمن يخطو فيه كل شيء إلى الأمام ويتسع مجال المعرفة” جولدزيهر، مذاهب التفسير الإسلامي، ص ص 345-346.
[7] – راجع محمد أركون :Lectures du coran ، ص 143.
[8] – المقال الوحيد الذي وجدناه حول هذا الموضوع هو مجرد مقاربة سريعة وسطحية وتمجيدية. انظر : Ahmed Hasan, The Political role of Ijmà’ ، المرجع المذكور.
[9] – راجع مثلا : Pierre Cuperly : Introduction à L’ibadisme et de sa théologie, Alger, 1984, pp. 168-177.
[1] – انظر مثلا Louis Gardet : L’Islam religion et communauté المرجع المذكور ص 289. وراجع كذلك Louis Milliot : Introduction à l’étude du droit musulman المرجع المذكور، ص 112.
[2] – راجع KAhmad Hasan : The classical definition of Ijmà’ المرجع المذكور.
[3] – ارجع إلى : Ahmad Hasan : Modern trends in Ijmà’ المرجع المذكور، ص 123.
[4] – انظر : محمد الناصر النفزاوي، الإجماع وأهله في الفكر الأصولي الإسلامي، المرجع المذكور، ص 18.
[5] – راجع Milliot المرجع نفسه، ص 107.
[6] – من هؤلاء الآمدي والبيضاوي والشوكاني والقرافي. راجع علي عبد الرازق ، الإجماع في الشريعة الإسلامية، ص ص 8-9.
[7] – انظر : Camille Mansour : L’autorité، المرجع المذكور، ص 72.
[8] – هو عبد المجيد تركي : راجع مقاله La notion d’Ijmà’ et son importance Kdans la pensée arabe contemporaine المرجع المذكور، ص ص 167-182.
[9] – انظر Gibb : Modern Trends in Islam, pp. 11-14.
وانظر كذلك فصل « Kahwa » لـ (K.N.Chaudhuri) بدائرة المعارف الإسلامية ط2 (بالفرنسية) باريس 1978. 4/469-475 وانظر حول مسائل مشابهة أقرها ضغط الرأي العام مقال “إجماع” لماكدونالد بالطبعة الأولى من دائرة المعارف الإسلامية، 2/438-440.
[10] – راجع Pierre Rondot : Le fonctionnement de l’opinion et l’Ijmà’ moderne en Tunisie المرجع المذكور، ص 19.
[11] – يتعلق الأمر بدعوة الناس إلى الإفطار سنة 1960.
[12] – انظر Pierre Rondot المرجع نفسه، ص 24.
[13] – انظر : رفيق العجم، الأصول الإسلامية منهجها وأبعادها، ص 129.
[14] – راجع Carl.A.Keller, Réflexions autour de la théorie et de la pratique de Ijmà’, p. 26.
[15] – المرجع نفسه، ص 33.
[16] – يوجد مع ذلك رأي شاذ من داخل النظرية السنية يسمح للإجماع بأن يكون أقوى من القرآن والسنة لتطرق النسخ إلى النص وسلامة الإجماع منه. انظر ابن قدامة (ت. 620 هـ) روضة المناظر وجنة المناظر في أصول الفقه ص 135.
[17] – أبو الحسن البصري، كتاب المعتمد في أصول الفقه 2/497.
[18] – راجع عبد المجيد الشرفي، الإسلام والحداثة، المرجع المذكور ص 164.
[19] – انظر Hungronje : Œuvres choisies المرجع المذكور ص 234.
[20] – رفيق العجم، الأصول الإسلامية، المرجع المذكور ص 132.
[21] – رفيق العجم، المرجع المذكور، ص 132.
[22] – رشيد رضا، تفسير المنار، المرجع المذكور 5/139.
[23] – انظر Lucie Pruvost : Une source du droit musulman : le consensus ou Ijmà’ وهو بحث محفوظ بمكتبة I.B.L.A. بتونس (21 صفحة).
[24] – انظر : Louis Milliot, Introduction à l’étude du droit musulman المرجع المذكور ص 115.
[25] – رشيد رضا، الخلافة ص 89.
[26] – عبد الكريم زيدان، الوجيز في أصول الفقه، ص 192-193.
[27] – محمد صادق الصدر، الإجماع في التشريع الإسلامي، ص 85.
[28] – انظر حوراني : The Basis of authority ، المرجع المذكور ص 39