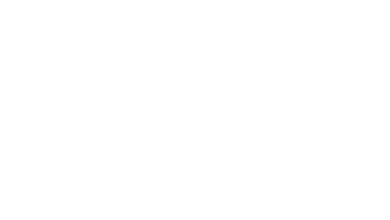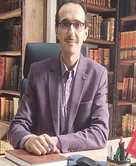الحدود التاريخية للدولة المغربية(محمد شقير)_3_
ثالثا : التقوقع الاستراتيجي
اتفق المؤرخون على أن منطقة شمال افريقيا ، شكلت ، من الناحية الاستراتيجية، ملتقى طرق الصراعات البشرية سواء عـلى الصعيد الإقليمي أو العالمي . وهكذا يرى أوجين كرنييه على أن هذه المنطقة قد شكلت ، وذلـك عبر كل الفترات التاريخية، ملتقى الطرق الكبير للغزوات البشرية. فقد كانت الحلقة التي كان من خلالها يتم اكـتـسـاح أوربـا و الـسـيـطـرة عـلى مـنـطـقـة الـبــحـر الـمـتوسط . ولهـذا السبب كانت قلعة حربية لها نيبال و جنسريك و عقبة ، كما كانت أيضا قاعدة انطلاق لايزنهاور. (3)
و فـي هـذا الـسـيــاق أيـضـا ، يـرى شـارل أنـدريــه جـولـيــان أن منطقة شمال افريقيا كانت تخضع دائما لتأثير ، و في بعض الأحيان ، لمصير حضارات أجنبية عنها . (4)
لـكـن رغـم كـل الفـتـوحـات الأجـنـبـية التي تعرض لها المغرب ؛ فإنه بقي محافظا على أصالة كيانه السياسي و ذلك نتيجة لعدة عوامل من أهمها :
أولا : تقلص رقعة الاحتلالات الأجنبية ؛ بحيث أن أغلب القوى الأجنبية لم تكن تحتل من تراب المـغـرب إلا بـعـض أطـرافـه ، فـالـقـرطـاجـيـون لم يستوطنوا إلا بعض المحطات التجارية على السواحل المغربية ؛ و الرومان لم يستطيعوا احتلال إلا المنطقة الشمالية بالمغرب(1) . كما أن البرتغال اقتصروا في احتلالهم على استيطان المدن الساحلية .
ثانيا : صعوبة المسالك الطبيعية و الجغرافية التي كانت تشكل عوائق رئيسية أمام أي زحف أجنبي . فالشريط المتوسطي لـم يــشكل أبدا طريقا للغزو(2) نظرا لا لتصاقه بجبال الريف الوعرة التي لم تكن تسمح بالمرور إلا لمنطقة المغرب الشرقي ذات السهوب الكثيفة(3)؛ كما أن الشريط الأطلسي كان بمثابة الدراع الواقي للمغرب نظرا لشواطئه الملتوية و غـيـر الآمنة(4) . أما مضيق تازة ، و الذي كا يشكل أحد مفاتيح المغرب الرئيسية، حيث سهل الكثير من الفتوحات و الهجرات و التبادل التجاري ، كان في نفس الوقت بوابة غير سليمة لخروج الفاتحين الأجانب نظرا لبيئته شبه الصحراوية و طبيعة القبائل التي كانت تعيش في هذه المنطقة ، و التي كانت تتسم بعدم الانقياد و التمرد . (5)
ثالثا : إن وجود المغرب في أقصى شمال افريقيا(6) و صعوبة المسالك الطبيعية التي كان يتميز بها ، جعلت كـل الفـتــوحات الأجـنبـيـة الـتي اكـتـسـحت الـمـنطقة تصله دائما في آخر المطاف و بعدما تكون قد فقدت معظم زخمها . (7)فالرومان لم يحتلوا المغرب إلا بعد سيطرتهم بوقت طويل ، على كل بلدان المنطقة، و الفتح العربي لم يؤثر كثيرا في المغرب بخلاف تونس و الجزائر ، الشيء الذي ساعده على الحفاظ على خصوصيته . (8)
وعموما فكل هذه العوامل أثمرت عن تميز الدولة بالمغرب بخصوصية تمثلت في عدة مظاهر .
2 – الـمـظـاهـر
يمكن أن نلخص هذه المظاهر في المناحي التالية :
أولا : النزعة الاستقلالية للدولة المغربية .
إن تواجد المغرب محصورا في إطار حدود طبيعية (المحيط الأطلسي غربا و البحر المتوسط شمالا و الصحراء جنوبا) جعل منه بـلـدا شـبـه مـعزول جغرافيا . فباسـتـثناء الجهة الشرقية ، و التي شكل فيها مضيق تازة البوابة الوحيدة و الصعبة لدخول المغرب، فإن مختلف الحدود الطبيعية الأخرى كانت صعبة الاختراق . و قد أثمرت هذه العزلة الطبيعية على تكون دولة في المغرب تميزت بنزعتها في الاستقلال .
و مما ساعد في تكريس هذه النزعة عاملان رئيسيان يتمثلان في :
– تـوفـر الـمغرب على حدود تاريـخـية؛ بـحيث أن نـهـر ملويـة، كان و على مر العصور ، حدا فاصلا
بين الدولة المغربية و باقي الكيانات السياسية التي كانت متواجدة بالمنطقة . (1)
– إن عزلة المغرب الطبيعية ، و التي تمثلت في وجوده في أقصى شمال افريقيا، وانحصاره في شبه جزيرة مـحـاطـا بـمـيـاه الأطـلسي و الـبـحـر الأبيض و المتوسط و و رمال الصحراء، أضفت على البلاد نوعا من الوحدة الجغرافية . (2)
وقد تمثلت هذه النزعة في قيام الدولة المغربية منذ نشأتها بالدفاع عن استقلالها و التشبت بهويتها و رفض الاندماج في كل الكيانات السياسية الغازية . فتاريح الدولة بالمغرب حافل بالمعارك التي تم خوضها ضد الاحتلال الأجنبي . فالحروب ضد الاحتلال الروماني، و الحركات الاستقلالية ضد الفتح العربي ، و المعارك ضد الاحتلال الايـبـري … تـشـهـد بـقـوة عـن النزعة الاستقلالية التي كانت تحرك الدولة بالمغرب و ذلك في مختلف مراحل تطورها التاريخي. وهذا ما فهمته كل القوى السياسية التي كانت تطمح إلى السلطة؛ بحيث أن أغلبها أقام شرعيته السياسية على تحرير البلاد أو الحفاظ على استقلاله السياسي . فالمرابطون و الموحدون و المرينيون نقلوا الحرب إلى الأندلس ليس فقط لجلب موارد للدولة بل أيضا لمواجهة عدو مجاور كان يطمح دائما لغزو المغرب . وهذا ما تم بالفعل بمجرد ضعف السلطة المركزية بالمغرب ؛ إذ تم احتلال مدينتي سبتة و مليلية ثم المدن الساحلية من طرف الاحتلال الايبري . لذا فإن السعديين و العلويين أقاموا شرعيتهم السياسية على تحرير البلاد و مواجهة كل التوسعات الأوربية . ولعل مشكل الصحراء الغربية و تحرير سبتة و مليلية ينمان ،لحد الآن، عن عمق النزعة الاستقلالية للدولة بالمغرب. هذه النزعة، التي تجذرت أيضا في الثقافة السياسية للمغاربة ، وذلك منذ القديم . وقد تجلى ذلك من خلال رد فعل السكان ضد الاحتلال الروماني و محاولته القضاء على استقلال البلاد و ذلك باغتيال بطليموس من طرف كاليكولا . و هكذا أشار التازي إلى ” أن الملكية الموريتانية رغم ضعفها، كانت عميقة الجذور في نفوس المغاربة . فرغم استيائهم من سياسية يوبا و ابنه ، فقد كانوا يرون فيها رمزا لاستقلالمهم . و هذا ما تفسره ثورة أيدمون. “(1)
وقد ساهمت هذه النزعة ، سواء لدى السكان أو الدولة ، في أن تحافظ هذه الأخيرة على استقلالها و كيانها الخاص و ذلك لفترات طويلة في تاريخها ؛ فالاحتلال الأجنبي للمغرب كان لا يعمر طويلا . وهذا ما جعل جوهر الدولة الـمغربـية و مـنطـقـهـا الخاص يـقـوم بالأسـاس على ضـمان اسـتقلالها . وقد عبر بول بالتا عن هذه الخاصية عندما أشار إلى ما يلي :
” هـناك بـلـدان يـتـمـيـزان بـمـوقع جـغـرافي و بعمق تاريخي ، و يحتلان مكانة خاصة بشمال القارة الافـريـقـيـة : فـفـي الشـرق هـناك مصر ، و في الغرب هنا المغرب الذي يعتبر أول دولة تشكلت في الغرب الاسلامي . لـكـن ، على عـكـس مـصـر التي كثيرا ما خضعت للاحتلال ، فالمغرب بشكل عام حافظ باستمرار على استقلاله .” (2)
ثانيا : الجوهر القبلي للدولة المغربية
يـشكـل الأسـاس القـبـلي المكون الجوهري لبنية الدولة في المغرب . فالأساس القبلي ارتبط بالدولة المغربية منذ نـشأتها ، و استمر ملتصقا بها في مختلف مراحل تطورها . و قد اتـفـق أغلب الباحثين ، على اختلاف مدارسهم، بأن الأساس القبلي يـعتـبر اللـبنة السيـاسية الرئـيسيـة للدولة المغـربية . فروبير مونتاني و جاك بيرك و واتربوري و غيرهم ، ورغم اختلاف أطروحاتهم حول طبيعة الدولة بالمغرب ، يتفقون حول نقطة مركزية تتمحور حول أهمية الـعـامـل الـقـبـلـي فـي تطور الدولة بالمغرب . و لعل ما يجسد هذا الاتفاق هو اعتماد جلهم على المرجعية الخلدونية التي نظرت للعصبية القبلية و دورها في نشأة الدولة . لذا فقيام بعض الباحثين المغاربة بمحاولة تصنيف الدولة إلى مرحلتين : مرحلة الدولة القبلية و مرحلة الدولة الشريفية(1) يلغي الدور الأساسي الذي بقي يلعبه العامل القبلي في السيرورة التاريخية للدولة المغربية . في حين ان هذا العامل شكل المحرك السياسي للدولة المغربية في مختلف مراحل تطورها ، سواء تعلق الأمر ببنيتها التنظيمية أو بمجالها السياسي .
أ – البنية القبلية للدولة المغربية
ارتكزت الدولة المغربية ، منذ نشأتها ، على المؤسسة القبلية سواء في الوصول إلى الحكم أو في تسيير دفة الحكم . فأغلب الأسر الحاكمة التي تـسلـمـت الـسـلطـة فـي الـمغرب كانت من أصل قـبلي ، فالـمرابطون و الـموحدون و الـمرينيون و السعديون و غـيـرهم كـانـوا مـنـحـدريـن من أصول قبلية . فالسعديون ، الذين غالبا ما يوصفون من طرف المؤرخين أنهم من أصول شريفية ، أقاموا دولتهم على أساس قبلي . وهكذا يشير هاردي بأن ” الدولة المغربية التي أسسها أحمد المنصور … هي نوع من الفيدرالية القبلية . ” . (2) فالشرف لم يكن وسيلة للحكم بقدر ما كان إيديولوجية للشرعية السياسية اقتضتها التطورات التي عرفتها الدولة بالمغرب . (3)
أما الأسر الحاكمة التي صعدت إلى الـسـلـطة باسم الشرف ، فلم يمكن في إمكانها أن تترفع عن اللحظة التاريخية أو عن التركيبة الاجتماعية التي انبثقت منها و عاشت فيها . فجنوب المغرب سكنته شرائح اجتماعية كانت تنتظم وفق تركبية قبلية تخضع للمنظومة القيمية و المعاشية التي كانت تحكم قبائل المغرب بما فيها قبائل الجنوب .
كما أن الأحداث التاريخية تشهد بأن السعديين عندما قادوا حركة الجهاد ضد الاستعمار البرتغالي أو عندما أرادوا مـواجـهـة خـصـومـهـم الـسـيـاسـيـيـن(1) أو تـنظـيم دوالـيب الــدولة كانـوا يـسـتندون إلى العناصر القبلية و التي كانت تتكون في أغلبها من قبائل السوس(2) . كـمـا اسـتـنـد سـلاطين علويون على كتل قبلية في الوصول إلى السلطة . فالمولى الرشيد استند مثلا على قبائل شراقة في فتح البلاد(3) ، أما المولى إسماعيل فقد وظف بشكل كبير العناصر القبلية في الجيش كالأوداية و أهل السوس …
ب – المجال القبلي للدولة المغربية
من المعروف أن الدولة المغربية قد انبثقت في وسط قبلي تميز بالأساس بخاصيتين رئيسيتين :
– الخـاصيـة الأولى تـتـجـلـى فـي وجــود اتــحـادات قـبلـية ممتدة تجسدت في مصمودة و صنهاجة
و زناتة و التي انـتـشرت تفريعاتها في مختلف مناطق المغرب . فقبائل مصمودة كانت تتنتقل مابين
جـبـال الـريـف و الـسـهول الأطـلـسـيـة و الأطـلـس الكـبـيـر ، وصنهاجة كانت تعيش في جنوب
المغرب ، و قبائل زناتة كانت مستقرة بالمغرب الشرقي . (1)
– الخـاصية الـثـانـية هـو أن الـكـيان القبلي في المغرب اتسم باختزانه لمكونات تنظيمية مستقلة تقوم
بالأساس على :
– الاستقلال بمجال ترابي خاص .
– الخضوع لبنية تنظيمية مستقلة ( الجماعة)
– الشعور بالانتماء المشترك ( الوعي القبلي ) (1)
لـذا فـقـد كـان تـاريـخ الـدولـة بـالـمـغرب هو تاريخ >> علاقة الدولة بالقبيلة “؛ هذه العلاقة التي تراوحت بين الـصـراع و الـتـعـاون و تـأرجـحـت بـيـن الـخـضوع و المقاومة ، نظرا لأن الدولة و القبيلة هما قبل كل شيء >> بنيات للسلطة”. (2)
فالقبيلة في المغرب كانت ترتكز بالأساس على بنية تنظيمية(3) تقوم بعدة مهام :
– اقتصادية تتمثل في تسيير شؤون الأرض و توزيع الماء.
– قانونية و تتجسد في تنظيم العلاقات بين أفراد القبيلة و حل النزاعات فيما بينهم .
– سياسية تتعلق بتحديد العلاقات بينها و بين باقي القبائل أو بينها و بين السلطة المركزية . (4)
و من ثـمـة ، فـإن الـهـاجـس الـرئـيسي للدولة في المغرب ، و ذلك عبر مختلف مراحل تطورها ، كان يتلخص في كيفية الـتـعـامـل مع هـذا ” الند السياسي ” سـواء مـن خـلال الـعـمـل عـلـى توحيده ( التجربة المرابطية و الموحدية) أو مـحـاولـة تــوظيفه و تفكيكه ( التجربة السعدية و العلوية ) . و هـذه الـوظيـفـة الـتاريـخـيـة التي التصقت بالـدولةـ الـمـغربـيـة مـيـزتها عن باقي دول المنظومة المتوسطية ، إذ أن الدولة في أوربا ( وخاصة في بلدان كإسبانيا و البرتغال و فرنسا) اهتمت بالأساس على إخضاع الكنيسة و الاقطاع .