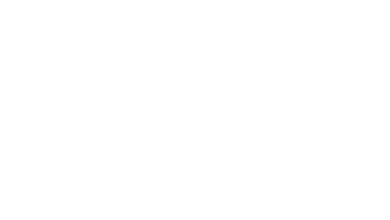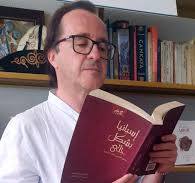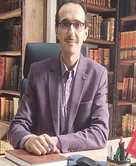الدراسات القرآنية عند الدكتور محمد عابد الجابري النسخ أنموذجا مقاربة نقدية(عبد الله الجباري)_1_
يعتبر الدكتور محمد عابد الجابري من المفكرين المشاهير في عصرنا، أثرى الخزانة العربية بمؤلفات ذات مواضيع متعددة، ولكنها مؤطرة في الغالب بتيمة الاشتغال على التراث العربي الإسلامي، تقويما ونقدا.
لم يكن الجابري رجل إجماع، وذهب فيه الدارسون طرائق قددا، منهم من اعتبره مجرد مقلد للمستشرقين، ومنهم من اتهمه بالسرقة العلمية لأفكار بعض المصريين، ومنهم من اعتبره من كبار المفكرين بلا تردد أو تعقب.
قد نختلف في تقييم أعمال الرجل، خصوصا أعماله الأولى، لكن بالنظر إلى أعماله التي ختم بها حياته، وهي الكتب التي اشتغل فيها على القرآن الكريم، نجده لا يرقى إلى مستوى المفكرين، ولا يُصنّف –اعتمادا عليها – ضمن الأكاديميين الذين يخضع لهم الباحثون وإن اختلفوا معهم في مخرجات البحث أو مدخلاته، وذلك عام على مستوى اللغة التي يكتب بها، أو على مستوى المنهج المعتمد، أو على مستوى العمق في التحليل والدراسة.
إن دراسة قضية ما دراسةً أكاديمية من قبل باحث يحترم نفسه، تفرض عليه التزود بالعُدّة الكافية ليخوض مغامرة اقتحام العقبة بنجاح، أو بأقل الخسائر الممكنة، أما إذا كان البحث سينصب على دراسة القرآن الكريم، باعتباره الكتاب المقدس عند المسلمين –بمن فيهم الباحث نفسه-، فما عليه إلا أن يتسلح –ليضمن نسبة من النجاح- بأنواع متعددة من الزاد، منها القرآن وعلومه، ومنها السنة النبوية، ومنها اللغة العربية الأصيلة، ومنها أو قبلها: الإخلاص والصرامة المنهجية، فتضبط الأولى قلب الباحث، وتضبط الثانية عقله وقلمه.
قد لا نجد هذه الضوابط مجتمعة عند الدكتور محمد عابد الجابري في كتاباته عن القرآن الكريم، وهي كتابات لو قُدمت غُفلا دون ذكر اسم مؤلفها، لظنها القارئ من بنات أفكار مستشرقي أوربا من حيث المحتوى، أما من حيث الشكل والمنهج، فكثير من الدراسات الاستشراقية تسمو عليها وتفوقها.
وإذا كانت الدراسات النقدية لمشروع الرجل تحتاج إلى تأليف أو مؤلفات مستقلة، إلا أننا سنكتفي من القلادة بما يحيط بالعنق، وسنخصص هذا المقال لموضوع النسخ الذي تناوله الدكتور الجابري في كتابيه:
- مدخل إلى القرآن الكريم. الجزء الأول في التعريف بالقرآن. (مركز دراسات الوحدة العربية، ط: 1. 2006).
- فهم القرآن الحكيم، التفسير الواضح حسب ترتيب النزول. القسم الثالث. (ط: 1. 2009).
أولا: على مستوى الشكل.
أول ما يطالعه القارئ من الكتب الأكاديمية؛ خصوصا إذا كانت من تدبيج الكبار؛ المقدمة والفهرس والمراجع. وبالعودة إلى الكتاب الثاني، وهو كتاب ضخم من 400 صفحة، فإننا نفاجأ في لائحة المراجع، ومن اطلع عليها وحدها يكاد يجزم أن الكتاب من إنجاز باحث في الإجازة.
بحث من هذا الحجم، يجب أن تغطي لائحة مصادره ومراجعه خمس صفحات في الحد الأدنى. أما كتاب الدكتور الجابري، فلم يتجاوز ثبت مراجعه نصف صفحة، تضم أحد عشر عنوانا، مع انعدام الدقة، وكأنها من وضع أحد الهواة، ومن أمثلة ذلك، أنه كتب في لائحته تلك:
- الحاكم النيسابوري: تفسير الواحدي.
- عبد الله الخفاجي: السيرة الحلبية.
- ابن هشام: سيرة ابن إسحاق لابن هشام.
يكتب اسم المصنِّف أولا، وهو الحاكم النيسابوري، ويُتبعه بعنوان المصدر، وهو تفسير الواحدي.
وتفسير الواحدي هو للواحدي وليس للحاكم النيسابوري، والحاكم النيسابوري ليس له تفسير يسمى تفسير الواحدي.
والسيرة الحلبية هي العنوان المشهور لكتاب “إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون”، وهي من تصنيف الشيخ علي الحلبي المتوفى سنة 1044هـ، وليس من تصنيف “عبد الله الخفاجي” كما أثبت ذلك الدكتور الجابري.
أما السيرة، فهي سيرة ابن هشام، اعتمد فيها على سيرة ابن إسحاق، وأضاف إليها وزاد، ولا يجوز ان نقول: سيرة ابن إسحاق لابن هشام.
قد يتذرع البعض بعدم ذكر لائحة المراجع كاملة، ويستعمل كلمة “بعض” أعلى الثبت، فيُغفل ذكر عشرة بالمائة أو أقل، أما أن يغفل تسعين بالمائة أو أكثر، فهذا لا علاقة له بالبحث العلمي، والصرامة المنهجية، التي يجب أن يكون الجابري قدوة فيهما.
ثانيا: على مستوى اللغة.
ثمة فرق كبير بين لغة الصحافة، ولغة الفكر والبحث الأكاديمي. وإذا كانت الدراسة للمفكرين الكبار، كان هذا التمايز أوجب وآكد.
من الصعب جدا أن تقرأ للباقلاني أو الغزالي أو ابن رشد، إلا إذا استجمعت جميع قواك العقلية، لأن كتاباتهم موجهة إلى النخبة، فلا تبتذل الخطاب، ولا تنزل به إلى أدنى الدركات.
وحري بنا أن نرجع إلى كتاب “إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول” للإمام الشوكاني، فإنه قرر أن يخاطب فيه الفحول ويرشدهم، فكتبه بأسلوب الفحول حقا، ويستحيل على المرء أن يقرأه ويستوعبه وهو متكئ على أريكة يحتسي كأس شاي. والأمر ذاته عند المفكر الكبير طه عبد الرحمن، فإنه يقدم للقارئ محتوى وأفكارا تجديدية، ويقدمها له بأسلوب لغوي صارم غير مبتذل، فيستفيد القارئ مرتين، يرتقي فكرا ومضموناً، ويسمو أسلوبا ولغةً.
لقد كان حريا بالجابري أن يرتقي باللغة المستعملة في كتابته، لأنه مفكر كبير أولا، ولأن الفئة المستهدفة من كتبه نخبةٌ ثانيا، ولأن الموضوع المطروق ذو علاقة بكتاب عربي مبين ثالثا. لكننا عدمنا هذا مع الأسف، فوجدنا عبارات دونية قد لا تختلف عن كتابات المبتدئين، ولنا أن نقرأ قوله: “لنشير إلى أن ربط عملية النسخ بقدرة الله إلخ، يناسب “ليس الآيات الكلام” فحسب، بل الأفعال والحوادث”[1]. ولو قال: “لا يناسب الآيات الكلام” لتفادى الركاكة التي تضمنها قوله: “يناسب ليس الآيات …”.
ومن الركاكة ننتقل إلى الابتذال اللغوي في الكتابة الفكرية، فنقرأ له: “هناك خمس آيات يلتمس فيها القائلون بـ”النسخ” في القرآن مشروعية هذه المقولة، ندرجها هنا حسب ترتيب نزولها وضمن سياقها لنتمكن من مناقشة مضمونها، على أساس ذلك المبدأ المثالي القائل: “القرآن يفسر بعضه بعضا”، أما روايات أسباب النزول فسيكون لنا حديث خاص بها، فليمسك عنا أصحاب البضاعة بضاعتهم إلى حين”[2].
ولو أنجز الجابري هذا البحث تحت إشراف أستاذ آخر لنبهه إلى تغيير الجملة الأخيرة بالخصوص، لأن القضايا الفكرية والموضوعات العلمية ليست بضائع يدعو التاجر نظيره إلى إمساكها أو تسليمها في جنبات الأسواق. وهذه العبارة تنزل بالكتاب الفكري إلى مستوياته الدنيا. بل قد نكيفها بأنها إهانة للقارئ الذي قد لا يخطر بباله أن يجد الحديث عن البضاعة في كتاب عن فهم القرآن الحكيم !.
ثالثا: على مستوى الخيال.
قد نكون في غنى عن الإشارة إلى ضرورة تمسك الأكاديمي البسيط في القضايا الفكرية الكبرى بالصرامة المنهجية في أعلى درجاتها، وإذا كان بصدد إنجاز دراسة عن القرآن الكريم، لزم أن تتضاعف الصرامة والتشدد، أما أن يتمسك الباحث بالخيال والتخمين، ويبني عليهما استنتاجات، فهذا لا يُقبل إلا في عالم الروايات والقصص والخواطر.
لم يلتزم الدكتور الجابري بالصرامة المفروضة، ولم يراع في ذلك مكانته في المجال البحثي، ولم يراع موضوع الدراسة الخطِر والمعقرَب، وسمح لنفسه بالتخيل والتخمين، فتجده يقول عن الآيات التي قيل بنسخ تلاوتها دون حكمها، وهي ما يسميها بالآيات المحذوفة من المتن القرآني: “ما ذُكِر أنه “محذوف” ينتمي إلى القرآن المدني وحده، ولم يذكر قط أن “المحذوف” طال شيئا ينتمي إلى القرآن المكي، هذا مع العلم أن إمكانية “سقوط آيات أو سور” كانت أكثر احتمالا في القرآن المكي منها في المدني، نظرا للظروف القاسية التي عاناها الرسول والمسلمون في مكة قبل الهجرة، ونظرا أيضا لأن الانتقال بالقرآن المكي إلى المدينة بعد الهجرة، وقبل فتح مكة، كان يتم في ظروف بالغة الصعوبة”[3]. ولنا مع هذا النص وقفات:
الأولى: نسخ التلاوة عند من يقول به، ليس معناه سقوط نص من القرآن أو ضياع له بفعل قلة الاحتياط أو الغفلة. بل معناه أن الله تعالى ينسخه ويبطله، وينسيه من صدور حفظته، وقد يرسل من يتلف ذلك النص إن كان مكتوبا. وحكَوا في ذلك وقائع. وأنا حين أقرر هذا المعنى، فإنني لا أقره ولا أقول به، ولكن الأمانة العلمية تفرض علي أن أقول ما يقوله أصحاب هذا الرأي بأمانة.
الثانية: ذهب الدكتور إلى أن حذف آية أو سورة من القرآن المكي مندرج ضمن “الإمكانية” وأنه “أكثر احتمالا”، وهذا غريب من وجهين، غريب لأن النسخ لا نثبته بالاحتمال، وغريب لأن الدكتور انتقد العلماء الذين أكثروا من القول بالنسخ في القرآن، وأنهم لم يعتمدوا على الأقوال القطعية، ومحل الغرابة أنه انتقدهم لأنهم لم يعتمدوا على القطعيات، وهو هنا يتسلح بالاحتمالات.
الثالثة: علَّل احتمالية النسخ [يسميه الآيات المحذوفة] بكون النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة عانوا ظروفا قاسية في المرحلة المكية، وهذا كلام صحيح لو كانت الآيات القرآنية من المواد أو الآلات أو الأجهزة التي نحتاج للحفاظ عليها إلى أماكن آمنة، ويمكن لقريش أن تفلح في تخريبها إذا ما بسطت عليها يدها. لنتذكر، أما الآيات القرآنية، فيحفظها النبي صلى الله عليه وسلم في صدره بعناية الله، ويحفظها الصحب الكرام، ومنهم من يكتبها، ومنهم من كان لا يكتبها للأمية الفاشية حينذاك. “لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه”.
الرابعة: يختم الجابري النص السابق بصورة كاريكاتورية محضة، حين يقول: “ونظرا أيضا لأن الانتقال بالقرآن المكي إلى المدينة بعد الهجرة، وقبل فتح مكة، كان يتم في ظروف بالغة الصعوبة”، ماذا يقصد بهذا الكلام؟
ما هي الظروف بالغة الصعوبة التي اعترضت نقل القرآن المكي من مكة إلى المدينة؟
هل القرآن المكي إنسان يخشى وعثاء السفر؟ ويخشى لحوق المشركين به؟
هل القرآن المكي سلعة كبيرة نحتاج إلى سترها وتغطيتها وتهريبها حتى نفلح في تنقيلها من مكة إلى المدينة؟
لست أدري عن أي قرآن يتحدث؟ وعن أي ظروف يحكي؟
ما يقال عن القرآن المكي يقال عن الشِّعر الذي كان ينتقل بسلاسة من قبيلة إلى قبيلة، ومن منطقة إلى أخرى، وكان ينتقل في أحلك الظروف وأصعب لحظات الحروب. والأمر هين جدا.
ويظهر الخيال أكثر في كتابة الجابري وترجيحاته -التي قد يكون لها صدى عند قرائه لا محالة- في قوله: “وكل ما يمكن قوله –على سبيل التخمين لا غير– هو أن يكون الجزء الساقط من سورة براءة هو القسم الأول منها، وربما كان يتعلق بذكر المعاهدات التي قد أبرمت مع المشركين، ذلك أن سور القرآن، بخاصة الطوال منها، تحتوي عادة على مقدمات تختلف طولا وقصرا، مع استطرادات، قبل الانتقال إلى الموضوع أو الموضوعات التي تشكل قوام السورة”[4].
يتكلم الجابري هنا عن جزء “ساقط” من سورة براءة. بمعنى أنه يتكلم في قضية مصيرية وكبيرة جدا، لذا كان ملزما في هذا المقام بالتسلح بأقوى الأدلة وأسطع البراهين، لكننا لا نجد عنده سوى عبارة “على سبيل التخمين لا غير”، فهل نعتمد على التخمين لنثبت موضوع الجزء الساقط من سورة قرآنية؟ وهل نعتمد على التخمين لنثبت أن الجزء الساقط كان في أول أو آخر أو وسط السورة؟
هذه مواضيع لا مجال فيها للخيال والتخمين، والخرص والظن، ولا محيد للباحث فيها عن القطع واليقين.
رابعا: على مستوى التدليس.
اجتهد الدكتور الجابري كثيرا ليثبت عدم وجود نسخ آيات القرآن، وبذل مجهودا في نقد الأدلة التي اعتمد عليها القائلون بالنسخ، وهي آيات قرآنية، ومنها قوله تعالى: “وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ” [النحل: 101].
قال الدكتور الجابري في سياق انتقاده للاستدلال بهذه الآية: “ذكر لها الواحدي وغيره سببا للنزول، ولكنه ذكر السبب نفسه لآيات أخرى”، ثم قال معلقا: “المفروض في سبب نزول آية ما يكون خاصا بها وحدها، وإلا لما صح اعتباره سببا في نزولها”، بناء على هذه المقدمة، يقول: “لعل هذا ما جعل القرطبي يعرض عن الرواية السابقة ليشير بصدد قوله تعالى: “وإذا بدلنا آية …” إلى رأي آخر، فكتب يقول: “قيل المعنى: بدلنا شريعة متقدمة بشريعة مستأنفة”، ونحن نرى أن هذا التفسير يحتمله السياق فعلا، فالآية التي تلي السابقة وهي قوله تعالى: “قل نزله [القرآن] روح القدس [جبريل] من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين”، تشير إلى القرآن ككل. وتتكامل مع السابقة.
على أنه إذا أمكن صرف معنى الآية هنا إلى “الشريعة” [شريعة موسى مثلا]، كما فعل القرطبي وغيره …”[5].
خلاصة قوله:
- كلمة “الآية” في قوله تعالى: “وإذا بدلنا آية …” ليس معناها “الآية” التي هي جزء من سورة القرآن، ومعناها “الشريعة”.
- ما قيل في سبب نزول الآية مرفوض عنده، لأنه ذُكر سببا لآيات أخرى.
- مال إلى “رأي” القرطبي الذي “أعرض” عن سبب الورود الذي ذكره الواحدي وغيره، وفسر “الآية” بـ”الشريعة”.
فهل أعرض القرطبي عن سبب النزول؟ وهل مال عن رأي الجمهور وتبنى الرأي الآخر؟
قبل إثبات نص القرطبي، يجدر بي أن أذكر سبب النزول الذي أورده الواحدي وغيره.
ذكروا أن المشركين قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي أتباعه بأمر وينهاهم عنه غدا، وما هو إلا مُفْترٍ، يقول الآيات من تلقاء نفسه، فأنزل الله تعالى: “وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ”.
بعد هذا، سنذكر نص القرطبي، ونبين تعامله مع سبب النزول هذا، هل أعرض عنه كما قال الجابري؟ وهل رجح رأيا مخالفا لرأي الجمهور الذين اعتمدوا على الآية لإثبات النسخ؟.
قال القرطبي: “[وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل] قيل: المعنى بدّلنا شريعة متقدمة بشريعة مستأنفة، قاله ابن بحر.
مجاهد: أي رفعنا آية وجعلنا موضعها غيرها.
وقال الجمهور: نسخنا آية بآية أشد منها عليهم.
والنسخ والتبديل رفع الشيء مع وضع غيره مكانه. وقد تقدم الكلام في النسخ في البقرة مستوفى. [قالوا] يريد كفار قريش. [إنما أنت مفتر] أي كاذب مختلق، وذلك لما رأوا من تبديل الحكم. فقال الله: [بل أكثرهم لا يعلمون] أن الله شرع الأحكام وتبديل البعض بالبعض”[6]. انتهى نص القرطبي.
يتبين من خلال هذا النص أن القرطبي لا يرجح ولا يميل إلى الرأي الذي انتصر وتحمس له الجابري، لذلك حكاه بصيغة التمريض [قيل]، ونسبه إلى [ابن بحر]، ولعل الجابري لم يعرف ابن بحرٍ هذا، ولو عرفه لتفطن إلى الأمر. وابن بحر هو أبو مسلم الأصفهاني، وهو المشهور في جميع الكتب الأصولية والفقهية والتفسيرية بأنه أنكر النسخ، ولعل القرطبي تعمد تجهيله فلم يورد اسمه المشهور، وهذه قرينة أخرى تعضد خلاف ما ذهب إليه الجابري.
وأضاف القرطبي إلى ذلك الرأي رأيين اثنين، أحدهما لمجاهد، وثانيهما للجمهور، وكلاهما في نسخ الآيات القرآنية.
ولم يكتف القرطبي بهذا، بل أضاف شرحَ وبيان معنى النسخ، وأحال إلى موضع سابق في تفسير سورة البقرة، ولو رجع إليه الجابري لاكتشف أن القرطبي يقول بنسخ آيات الأحكام، ولا يقول بنسخ شريعة لاحقة لشريعة سابقة، ولكن الجابري دلّس على قرائه، وبيّن لهم أن القرطبي يقول بنسخ الشريعة ولا يقول بنسخ آحاد الآيات القرآنية.
ولما انتقل القرطبي لتفسير الجزء المتبقى من الآية، اعتمد على سبب النزول السابق بحروفه، فبيّن أن قريشا قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كاذب مختلق بعدما رأوا تبديل [أي: نسخ] الحكم، ثم ختمه بقوله عن كفار قريش: لا يعلمون أن الله شرع الأحكام وتبديل البعض بالبعض.
وهذا صريح فصيح في أن القرطبي يقول بنسخ آيات القرآن، وتبديل البعض بالبعض، بخلاف ما دلسه الجابري على قرائه.
وصريح في اعتماده على سبب النزول المذكور، بخلاف ما دلسه الجابري على قرائه أيضا.
وهنا أسجل مسألة مهمة، وهي أن الجابري كانت له القدرة على الجلوس أمام كتاب
تراثي مكوَّن من مجلدات، يستخرج منه ما أراد استخراجه من المعلومات، بخلاف الكثرة
الكاثرة من قرائه، الذين لا يستطيعون الرجوع إلى الكتب الطوال، فيقابلون ما كتبه
الجابري بالإذعان والتسليم، فلا يراجعون المصادر، ولا يكتشفون تدليساته.
[1] الجابري، فهم القرآن الحكيم، القسم الثالث: 108.
[2] الجابري، فهم القرآن الحكيم، القسم الثالث: 102.
[3] الجابري، المدخل: 229.
[4] الجابري، المدخل: 231.
[5] الجابري، فهم القرآن الحكيم، القسم الثالث: 102 -103.
[6] القرطبي، الجامع لأحكام القرآن: 10/176.