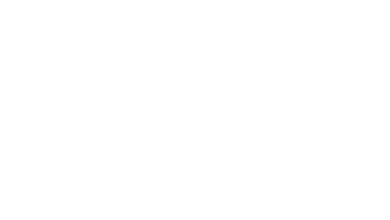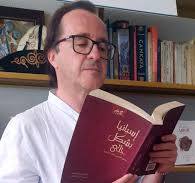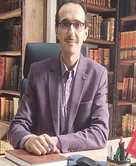عاهات الجسم السياسي العربي ومهمة الثورة الديمقراطية(بنسالم حميش)_1_
في باب تجاوز بعض تلك العقد
إن جاز لديمقراطية القرب والتفضيل الاجتماعي أن تدعي لنفسها امتيازا ما، فبشرط أكيد يتبلور أكثر فأكثر في إقامة رؤيتها السياسية الثقافية على ثوابت استراتيجية متكاملة ثلاثة، نذكرها تحديدا لكونها غير محققة بعد ولا فاعلة في واقع الحال بما يضمن ترسخها وتطورها.
1 ـ التجذر في الإرث العربي ـ الإسلامي الذي يلزمها، أي ديمقراطية القرب، الاضطلاعُ به كوريث للقيم الإسلامية من مساواة وتضامن وعدالة، وكذلك لثقافة الإسلام الثرية العميقة، سواء الروحية منها والدنيوية.
2 ـ التملك الوظيفي الفاعل للحداثة، ليس كسلعة تعويضية ersatz أو سوق للمنتوجات الاستهلاكية، بل كمعين لقيم مضافة، نافعة ومنتجة، وكحقل بحث وإبداع في سبيل ترقية الإنسان والوجود الاجتماعي. وبالتالي فالتحديث الحق لا ينبني ضدا على الشخصية الهويتية الأصيلة، بل يتقصد خدمة صحتها ونموها المطّرد.
3 ـ الانخراط الحيوي في روح الديمقراطية كنسق إجماعي، تلغي أركانُه المؤسسة كل شكل من أشكال الاعتباط والحكم الفردي، وتعطي لمجتمع المواطنين حق تشغيل قاعدة التناوب والمساهمة في إدارة الحياة السياسية وانتخاب ممثليهم وحكامهم ومراقبتهم وكذلك محاسبتهم وإسقاطهم حتى ولو كانوا من الجناح الأصولي. إن السياسة كميدان خصوصي هو بامتياز ميدان البرنامج والفرضية والتجريب، وكممارسة جد إنسانية ليست البتة بمنأى عن الفشل والخطإ ومواطن الضعف والزلل. وبالتالي وحدها المؤسسة الديمقراطية قادرة على مدها بطاقات العمل النقدي والتصحيح والتطور، وعلى تزويدها بالدم الجديد والفاعلين الجدد، وتمتيعها إذن بأسباب المصداقية الإجرائية والتقدير.
في جميع الأحوال وسعيا إلى رفع الضغوطات الهيمنية، إن أعز ما يطلب ويقوم كدعامة مرجعية لا مناص منها هو:
أ ـ أن تسقط الحواجز الذهنية والنفسية حتى تصلح وتعمل قنوات التواصل بين الأسر والاتجاهات السياسية والثقافية داخل المجتمع الواحد؛
بـ ـ أن نُجمع على أن التدين الخالص هبة ربانية وهداية من الله، كما يؤكده في غير ما موضع إسلام التسامح واليسر واللاإكراه، وأيضا على أن معالجة الشؤون الدنيوية أو الزمانية المحايثة المتقلبة موكولة أساسا إلى البشر، أفرادا وجماعات أحرارا ومسؤولين.
عن الشق الثقافي:
إن حالة الهيجمونيا والتتبيع لواقع، وإنها بالتأكيد لا تقف عند حدود السياسي والاقتصادي والعسكري بل تتعداها، كما ألمحنا، إلى الحقل الثقافي والذهني. والأمثلة على هذا كثيرة ومعروفة، لكن من بين أرقها وأبلغها هذا المثال: اللغات تُعرض وتُصنف على منوال العملات النقدية، التي تفرض القويةً منها نفسها على التي دونها كمرجع قياس وتقدير، وكذلك تفعل اللغات القوية في حق اللغات المخفضة أو المأزومة، بحيث قد تدفع مستعملي هذه الأخيرة إلى الاعتقاد أن لغاتهم الضعيفة التداول والتأثير، إن هي إلاّ عملات قردة أو ما شابهها ليس غير…
في حقل الفكر والثقافة الغربي، يجوز القول بأننا ـ على الأقل عربياً ومغاربياً ـ لا نبرز كذوات مفكرة ومرجعيات مؤسسة، وإنما ـ في الغالب الأعم ـ كمواضيع للإستخبار والمعرفة التفعية لا غير، بدليل تغييبنا شبه المبرم من وسائل إعلام الغرب ودور نشره الوازنة النافذة. وحاضراً تحت التأثيرات المختلطة للعولمة والفكر الواحدي، حتى هذا التوجه أخذ يميل أكثر فأكثر إلى أن يكون انتقائياً، وظيفياً، ريْعيا أي منشغلا أساساً بحقول الستراتجيا الجيو ـ سياسية والنفط والأصولية أو التطرف الديني..
حينما ننظر إلى الأمور عن كثب، فإننا، ثقاقياً، لدى فئات غربية واسعة نكاد لا نوجد ولا نظهر في حقل معرفتها وإدراكها إلاّ قيد ما يشبه ثقبها الأسود. فعموم القراء الفرنسيين مثلا لا يعرفون عن الأدب المغاربي إلاّ النزر اليسير، حتى مما فيه مكتوب باللغة الفرنسية، أما عن أساسه الجوهري المكتوب بلغة الضاد فلا تسألوهم كيلا لا تصعقوا. وعلى صعيد أوسع، حسب ملاحظة لإدوارد سعيد، لا يعرف عموم القراء الأمريكيين من التراث العربي كله إلاّ النبي لجبران خليل جبران، المكتوب أصلاً بالإنكليزية (12). ولعل ما يغني عن الاسترسال في ضرب الأمثلة هو خطاب نجيب محفوظ إلى الأكاديمية السويدية ولجنة نوبل بمناسبة فوزه بهذه الجائزة لسنة 1988؛ فمما جاء فيه: “سادتي.. أخبرني مندوب جريدة أجنبية في القاهرة بأن في لحظة إعلان اسمي مقرونا بالجائزة ساد الصمت وتساءل الكثيرون عمن أكون، فاسمحوا لي أن أقدم لكم نفسي بالموضوعية التي تتيحها الطبيعة البشرية”، إلخ.
وبالتالي، قد لا نغالي إذا قلنا إن تلك الفئات، بما فيها المثقفة، لا تترك لنا من سبيل إلاّ التماهي معها والمصادقة الطيعة على تعريفتها أو وصيتها التي يمكن صياغتها على هذا النحو: إذا أردتم اللحاق بالشمولية المعولمة، كونوا كما نموقعكم ونتمثلكم، وكما نبرمجكم ونتوقعكم، اندمجوا في ما نريد أن تكونوا عليه قلبأ وقالِباً، ولفظاً ومعنى.
ـ في الحقول المذكورة، تُرى من نحن وما هي مواقعنا وآثارنا؟ والحال أن هوساً متزايداً بات يقضي بأن نتجرد من كل ما نحن وما لنا، وذلك قبل الوقوف أمام الآخر القوي المزدان بكل ما كان وما يريد أن يكون. إنه إتلاف قدراتنا الذاتية على إدهاش العالم والإسهام في تنويره، وكذلك إلى تبديد إرادتنا في أن نعيش معاً، ونكوّن مجموعة قوية مَهيبة. ومن ثم يبرز نزوع إيديولوجي إلى إضفاء صبغة التطبيع واللاإشكال على الوجود التبعي العيلي.