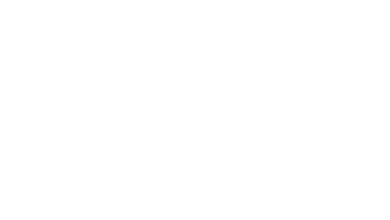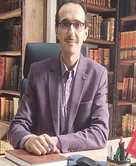في الحاجة إلى الأدب (نادية لوطفي)_1_
مقدمة :
الأدب يعنى به كل الفنون التي يمكن التعبير بها عن المكنونات النفسية والخواطر والرؤى والتصورات والأفكار التي تتردد في خيال الإنسان وإدراكه، وقد كان الأدب حاضرا في كل الحضارات والثقافات بأشكال مختلفة وبنسب مختلفة وتصورات مختلفة أيضا، تعبر عن مرجعيات تلك الثقافات وطبيعة معارفها، فنجد مثلا فن الرواية والقصة بأنواعها، والمسرحية والمقامة والمقالة والشعر وفنون عدة في كل الثقافات، وجدت لتعبر عن واقع أصحابها وأفكارهم واحتياجاتهم، كما تصف أنماط عيشهم وتطعاتهم، وكان مفهوم الأدب عند العرب مرتبط ببعض الخصال النبيلة كالكرم، إذ كانت العرب تطلق على الطعام الذي يجتمع حوله القوم مأذبة، ثم تطور مفهوم الأدب بمجيء الإسلام إلى كل ما هو خلق فضيل وسلوك حسن ثم تطور بعد ذلك مفهوم الأدب إلى مجموعة من الفنون النثرية والشعرية وغيرها .
إن الثقافات التي قاومت عامل الزمن واستطاعت أن تستمر طويلا وتحدث تأثيرا لابد كان لها زاد من الأدب مكنها من ذلك أو ساعدها عليه، بل إنه كان سببا في انتقالها خارج حدودها الجغرافية، فالأدب العربي تمكن من تجاوز دغرافية المجتمعات الناطقة بالعربية يدل على ذالك وجوده داخل تقافات غير عربية، كذلك الأدب الروسي يعد من أشهر الآداب حيث برع رواده في الإبداع في مختلف فنونه خاصة فن الرواية، حيث تعتبر الأعمال الروائية الروسية من أهم الأعمال الأدبية مما مكن الأدب الروسي عموما من احتلال الصدارة ليصبح أدبا عالميا، كذلك مختلف الثقافت التي استطاعت عبرود حدودها الجغرافية كان للأدب دور مهم في ذلك.
- واقع تراجع دور الأدب في الحياة التعليمية والإجتماعية العامة:
إن أحد أسباب التراجع الكبير على المستوى اللغوي لذى فئات عريضة من الطلبة والباحثين على اختلاف مستوياتهم هو هذا الغياب التام للتكوين الأدبي والقراءة الأدبية، فاللغة هي وسيلة التعبير في مختلف مجالات الحياة، كالصحافة والإعلام والأخبار والتقارير الإدارية في مختلف الإدرات، وقد كشفت عدة تقارير متوالية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين وكذلك وزارة التربية الوطنية بالمغرب مثلا، منذ عقدين من الزمن تقريبا تراجعا متواليا في نسبة الطلبة داخل الشعب الأدبية في مختلف مراحل التعليم .
ففي الأونة الأخيرة ارتبط التوجه الأدبي خصوصا لذى المتمدرسين والعلوم الإنسانية عموما بالتراجع في الذكاء والفطنة، فمن يتوجه من الطلبة إلى المسالك الأدبية غالبا ما يتهم بكونه قليل الفهم لا يقدر على ولوج الشعب العليمة، فيتجه إلى الشعب الأدبية نظرا لضعف قدراته في تحصيل المواد العلمية كالرياضيات والفزياء، وهو ليس مجرد إتهام، بقدر ما هو واقع تؤكده إحصاءات لمؤسسات رسمية، فقد كشف شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في تصريح له بمجلس النواب، أواخر الموسم الدراسي 2024، أن 73 في المائة من المترشحات والمترشحين لاجتياز امتحانات نيل شهادة الباكالوريا المتمدرسين برسم هذا الموسم، يتابعون دراستهم بالشعب العلمية والتقنية، بينما 26 في المائة فقط بالشعب الأدبية والأصيلة، و1 في المائة بالشعب المهنية، هذا التباين بين نسب المترشحين، يدل على أن الفئات التي تتوجه إلى الشعب العلمية، هي في الغالب فئات استطاعت اكتساب قدرات وذكاءات مختلفة، في حين تبقى نسبة الطلبة الذين لم يسعفهم واقعهم التعليمي من اكتشاف ذكاءاتهم و تطويرها هم من يلجون الشعب الأدبية وهذا واقع له إكراهات ودوافع وأسباب يصعب بسطها في هذا المقام، وحسبنا التنبيه إلى وجودها وضرورة العودة إلى تقييمات المؤسسات الساهرة على التريية والتعليم وأراء الخبراء في ذلك.
ثم إن هذا التوجه نحو الشعب العلمية، ليس مجرد اختيار له دوافع إقتصادية واجتماعية، بل ينم عن نظرة تنقيصية للشعب الأدبية، أنتجها واقع الخريجين من الشعب الأدبية و العلوم الإنسانية، هذا بالإظافة إلى ما يفرضه الوضع الإقتصادي وواقع سوق الشغل، إذ أصبحت الشعب الأدبية تخرج أفواجا من العاطلين الذين لا يجدون مجالا يندموجون فيه داخل سوق الشغل بعد تخرجهم غير التعليم، فلا يمكن لمجال التربية والتعليم أن يستوعب جميع الأعداد المتخرجة سنويا، مما يجعل خريجي شعب الآداب والعلوم الإنسانية يجدون أنفسهم في مواجهة مع معضلة البطالة، كما أنهم لطبيعة تكوينهم لايستطيعون الإندماج في مهن أو حرف أخرى بعيدة عن تكويناتهم، لذلك فالتوجهات الأدبية أصبحت لها سمعة سيئة يتخوف من ولوجها المتعلمين كما يتخوف منها أباؤهم وهو تخوف مشروع.
لكن المطلب، ليس هو إعادة الإعتبار للتوجهات الأدبية وإن كان مطلبا مهما بالنظر إلى مستقبل الأجيال، ومكانة العلوم الإنسانية في التنمية مستقبلا، وإنما المطلب هنا هو إعادة الإعتبار للأدب في مختلف التكوينات سواء كانت علمية دقيقة أو أدبية صرفة، بحيث هو جزء من التكوين الذي ينبغي الإهتمام به وظبطه وإعادة الإعتبار لمكانته وأهميته، بعيدا عن سوق الشغل وهيمنة المنطق الإقتصادي، فالمتخرج من المدرسة العليا للمهندسين، أو كلية الطب أو التجارة أو غيرها لا يعفى من الإلمام بالأدب، ولا يعذر بجهله للعربية كلغة وفنونها الأدبية في التعبير والقراءة والوعي، فالأدب يشكل الوعي أولا والوعي يلعب دورا مهما في حياة الفرد والمجتمع، حتى يتحقق التوازن بين الفكر والمنطق الإقتصادي، لأجل تحقيق جودة الحياة، فالحياة التي يتوفر فيها الجانب الإقتصادي ويغيب فيها الجانب الأدبي والثقافي والفكري، قد تنعكس سلبا على الفرد والمجتمع.
- 1. : دور الأدب في إنشاء الملكة اللغوية التعبيرية:
للأدب دور وظيفي في إنشاء الملكة اللغوية لذى الشخص، وهي ملكة تنمي الفكر والذوق، والملكة مأخودة من الملك، يقال: ملك الشيء أي حازه وانفرد بالتصرف به، فهو مالك، ويقا ل: هو يملك نفسه .[1]هي صفة راسخة في النفس.[2] فالنفس تحصل لها هيئة بسبب فعل من الأفعال، ويقال لتلك الهيئة كما في التعريفات عند الجرجاني كيفية نفسية وتسمى حالة، فإذا تكررت ومارستها النفس حتى رسخت تلك الكيفية فيها وصارت بطيئة الزوال فتصير ملكة“ وقال ابن فارس مأخوذة من ملك، وهو أصل صحيح يدل على قوة في الشيء وصحة، فيقال: ملك الشيء ملكًا: حازه وانفرد بالتصرف فيه، فهو مالك.
وقد تحدث الأستاذ محمد الدريج [3]عن الملكات في إطار إعداد الرؤية التربوية، فعرف الملكة على أنها” تركيبة مندمجة من قدرات ومهارات واتجاهات، تكتسب بالمشاهدة والمعاينة، وترسخ بالممارسة وتكرار الأفعال، في إطار حل مشكلات، ومواجهة مواقف، والملكة قابلة للتطوير والتراكم المتدرج هيآت، حالات، صفات. ويكون لها تجليات سلوكية خارجية حذق، كيس، ذكاء، طبع”[4] وأضاف “مفهوم الملكات من المفاهيم الغنية في تراثنا العلمي والتربوي، حيث نجد لها استعمالات كثيرة ومعاني متعددة ومضبوطة تتمحور كلها حول اعتبار الملكات من أهم ما يمكن للفرد أن يكتسبه وأن ينتجه في نفس الآن، على مستوى فكره وشخصيته بشكل عام، وفي جميع أنشطة الحياة وفي مختلف العلوم الصناعات”[5]
ثم بين دوافع اختياره لنظرية الملكات في المجال التربوي التعليمي بقوله”إن ما يبرر اقتراحنا لمدخل الملكات، هو العمل والاجتهاد لتأصيل النشاط التربوي، وإيجاد بدائل مستمدة من تراثنا التربوي، والسعي في نفس الآن، لإغناء النماذج والمقاربات الحالية والمستجدة في الساحة التربوية والتعليمية، بهدف عقلنة التدريس، وجعله أكثر فاعلية واندماجا، وتطويره من خلال تربية غنية ومبدعة، دون التضحية، باسم العولمة، بخصوصيتنا واستقلالنا” “[6]
وانطلاقا من التعريفات السابقة اللغوية والإصطلاحية، يتبين أن الملكة صفة في النفس وهي تجمع بين الفطري والمكتسب بحيث نجد ملكات تكون في الشخص كسليقة وهناك ملكات يكتسبها بحدقته واحترافه في تخصصه عمله وهو ا ذهب إليه أبن خلدون في تحديد أنواع الملكات وكذلك ما قال به صاحب كشف الضنون “لكل علم مسائل كثيرة، وحصولها عبارة عن الملكة الراسخة فيه، وهي لا تتم إلا بالتعلم.( والتدرب ب[7] فهناك ما يكتب عن طريق الدربة الخبرة والتكرار لكن لايمنع من وجود قابلية لذى الشخص فطرية في تحصيل الملكات وتطويرها وهو ما يميز ناقد عن أخر فهناك من يمتلك مقومات علم ما لاكنه لا يمتك ملكة فيه وهناك من يجمع بين الملكة ومقومات العلم فيكون أداؤه أقوى وأدق كما قال ابن خلدون وذلك “ أن الحذق في العلم والتفنن فيه والاستيلاء عليه، إنما هو بحصول ملكة في الإحاطة بمبادئه وقواعد ه“[8] فاعتبر الملكة نوع من الإبداع الذي يتطلب بالإضافة إلى المهارة والدقة يتطلب ذوق ورغبة إداعية تكون مسؤولة عن تشكل الملكة و تطورها.
و الملَكة اللغوية كما ذهب إلى ذلك الدكتور عصام البشير المراكشي “هي سجية راسخة في النفس، تمكن صاحبها من قوة الفهم لدقائق الكلام العربي الفصيح، وحسن التعبير عن المعاني المختلفة بلسان عربي سالم من أوضار العجمة ومفاسد اللحن، مع القدرة على الجمع والتفريق والتصحيح والإعلال ونحو ذلك ….وللملكة اللغوية أركان ثلاثة: أولها: راجع إلى الفهم العميق الذي يغوص في دقائق الكلام الفصيح. والثاني: راجع إلى التعبير الشفوي والكتابي، بلغة فصيحة سليمة من العجمة، بعيدة عن الركاكة. أما الثالث: فراجع إلى الصناعة اللغوية، التي تُدرَك بطول الممارسة، حتى يصير الممارس قادرًا على الجمع بين المتماثلات، والتفريق بين المختلفات، والحكم بالصحة أو الفساد على التراكيب والمفردات. [9]
وانطلاقا مما سبق فإن التنبيه على أهمية الأدب في صنع الملكة اللغوية والتعبيرية من صميم العملية التعلمية، إذ يكسب المتعلم تلك المهارات البيانية والبلاغية البديعة التي تخلق له لسانا تعبيريا متمكنا من اللغة، كما أنه يسهم في إثراء وعائه الفكري بحيث “تمكن النصوص الأدبية المتعلم من جانبين، جانب لغوي يتمثل في إثراء ونضج عقله وهذا بالإلمام بأسار اللغة، وجانب معرفي يتمثل في تنمية الملكة الفكرية الإبداعية حتى يتمكن من توظيفها في كتابة رسالة، دعوة، حوار، تعير كتابي أو شفوي، أوقصة تثري لغته وتخاطب قلبه وتشبع خياله الجامع، أو قصة شعرية قصيرة تطربه بإيقاعاتها الموسيقية، حيث أن كل مستوى مرتبط بالآخر وكل نشاط متعلق بنشاط آخر، لآن اللغة وحدة متكاملة، بها يستطيع المتعلم أن يجد نفسه محيطا بنصوص مختلفة والتي تمكنه من توظيف كل الأنشطة اللغوية فالنص ضروري في حياة المتعلم ” [10] ثم إن كتب الأدب لها دورًا مهمًا في تصحيح الذوق اللغوي وإصلاح أحوال النفوس، وتحصيل ذلك في المرحلة الأولى يكون بالاستئناس بالقراءة الأدبية، وذلك بمطالعة مجموعة من الكتب، كـ”المنتخب من أدب العرب” لعلي الجارم وزمرة من المؤلفين، و”جمهرة خطب العرب” و”جمهرة رسائل العرب” لأحمد زكي صفوت، ثم ينتقل الطالب إلى حفظ الأشعار كالمعلقات، وقراءة كتب الأدب الأصيلة، مثل: “أدب الكاتب” لابن قتيبة، و”الكامل” للمبرد، و”البيان والتبيين” للجاحظ. ثم ينتقل إلى القراءة الأدبية الموسعة، فيطلع على أشعار فحول الشعراء في عصور الاحتجاج كحسان بن ثابت والحطيئة والفرزدق وجرير والمتنبي وأبي تمام، ويتفحص كتب الأدب فينهل منها، مثل: “الإمتاع والمؤانسة” للتوحيدي، و”نفح الطيب” للمقري، ومقامات الهمذاني والحريري، وكتب الأمثال، ولا بأس في مطالعة كتب الأدباء المعاصرين، كشوقي ضيف والرافعي والزيات والعقاد ومحمود شاكر.[11]
[1] ابن منظور، لسان العرب 493_492\10 مادة ملك، وابن فارس، معجم مقاييس اللغة 5 . .251 /
[2] أنيس، ابراهيم وآخرون، المعجم الوسيط ، ط 2 ، مادة ملك 2 886 /
[3] محمد الدريج خبير علوم التربية بجامعة محمد الخامس بالرباط له إسهامات مميزة في الشان التربوي
[4] محمد الدريج “التدريس بالملكات نحو تأسيس نموذج تربوي أصيل في التعليم” مجلة كلية علوم التربية العدد 5 السلسلة الجديدة 1013 ص 10
[5] نفس المصدر ص 10
[6] نفس المصدر السابق ص 10
[7] الرومي مصطفى كشف الضنون 54\1
[8] ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد، مقدمة ابن خلدون ، ط 6 ، دار القلم، بيروت، 1986 ، ص 430
[9] عصام البشير المراكسي، تكوين الملكة اللغوية نماء للبحوث والدراسات
[10] جمال بلبكاي، دور النصوص الأدية في اكتساب اللغة لدى المتعلم وفقا للمستويات الإفرادية، التركيبية والنفسية.مجلة المقدمة للدراسات الإنسانية والإجتماعية المجلد 07 العدد 02 ديسمبر 2022، ص 445_446. ص 2.
[11] عصام البشير المراكسي، تكوين الملكة اللغوية نماء للبحوث والدراسات،