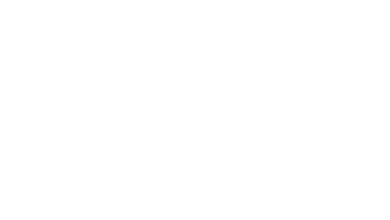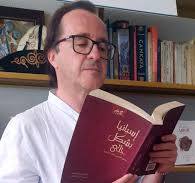العلماء في الخطاب السلفي المغربي:(عبد الرحمن منظور الشعيري)
يتميز الخطاب السلفي العربي بإعلائه من مكانة علماء الشريعة، التي تتمحور مهامهم في العقل السلفي عامة، والمغربي كجزء منه حول مفردات ” الذود عن العقيدة الصحيحة والتوحيد” “ومحاربة الشركيات والبدعيات” في المجتمع المسلم[1] بينما تمنح أدبيات “السلفية الجهادية” أحقية الزعامة الدينية للعالم بمدى تركيزه على معطى مواجهة “الطاغوت” المتجلي في الأنظمة الحاكمة والغرب بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية.[2]
ويشترك الخطاب السلفي المغربي كذلك مع الخطاب الديني الصادر عن الحركات الإسلامية الفاعلة في الحقل السياسي في الدعوة إلى تفعيل أدوار وظائف علماء الدين في المجتمع ومؤسسات الدولة، لكن ما يميز المقاربة السلفية لوظيفة نخبة العلماء عن نظيرتها الحركية، هو تشديدها على البعد “العقدي” “والتشريعي” “والقانوني” في المسار الذي تقترحه للفعل الديني للعالم في المجتمع، ومن ثم يتحتم على العلماء وفق هذه المقاربة الانضباط والامتثال للمنهج السلفي في العقيدة والفقه[3] بل وحتى في السلوك اليومي (طريقة اللباس، التحية …) على اعتبار أن الشخص السلفي سواء كان عالما للدين أو من عامة المسلمين عليه تجنب الشبهات في العقيدة خاصة في مسائل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وكذلك في مسائل القدر وفضائل الصحابة.[4]
فعالم الدين في التصور السلفي المغربي بشقه التقليدي أو الحركي هو: المتضلع في ضبط النصوص الإسلامية من الكتاب والسنة، أي المتخصص بعمق في ضبط “النقل” بلغة علوم الشريعة، وإن على حساب امتلاك فقه الواقع وآليات الاجتهاد المرتبطة بإعمال “العقل” والمقاصد. لذلك نجد لدى أتباع التيار السلفي بالمغرب إعجابا كبيرا بالعلماء والدعاة المشارقة المتأثرين بالمدرسة الوهابية في الإدراك الكلي للدين عقيدة وشريعة وفق انضباط صارم لفتاوى الشيخ ابن تيمية (1263م -1328م) وتعاليم الشيخ محمد بن عبد الوهاب (1703م – 1791م) التي تتأسس نظريا وفق التراتبية التالية:
- تحقيق التوحيد.
- التحذير من الشرك.
- الولاء والبراء.
- الاتباع ونبذ الابتداع.
- إقامة الدين وتحكيم الشريعة.[5]
ويعتبر ذو الفقار بلعويدي أحد الرموز السلفيين المنتظمين في الكتابة بجريدة السبيل المحسوبة على التيار السلفي التقليدي بالمغرب، أن وظيفة العلماء أوسع من الوعظ والإرشاد، بل تشمل الرقابة على التعليم والفن والإعلام والثقافة والسياحة والاقتصاد وقضايا الحريات، ومسائل حقوق الإنسان[6] وهذه الرقابة بحسب الداعية السلفي تنبني على جوهر وظيفة العلماء التي تقوم على أساس إقامة شريعة الله في الأرض، ثم حراستها، وتغليب الحق على الباطل، والمعروف على المنكر، والخير على الشر.[7]
وقد ساهم المناخ الثوري في بداية الربيع العربي، والحراك السياسي لحركة 20 فبراير بالمغرب، في التطوير النسبي للخطاب السلفي المغربي، للخروج من منهجية الردود والجدل العقدي حول قضايا البدعة والتكفير والحاكمية، إلى محاولة التبلور كخطاب سلفي إصلاحي في عمومه، صار يؤمن بالمشاركة السياسية والمدنية، وأكثر انفتاحا على مختلف أطياف المجتمع السياسي والحقوقي، ومن المؤشرات على ذلك، نلحظ كيف أصبحت مقالات الشيخ محمد الفيزازي أكثر نضجا ووسطية في تعاملها مع مكونات الحقل الديني وفي مقدمتهم العلماء، الذين اعتبرهم في مقال/ اقتراحي حول الدستور قبل الاستفتاء الدستوري لفاتح يوليوز2011 “من المكونات الأساسية المطلوب التنصيص على وجودها دستوريا في مجلس النواب، لكي تلحق وفق منظور الشيخ السلفي” بمجلس النواب غرفة تضم هيئة مجتهدة في النوازل والمستجدات متكونة من كبار أهل العلم وأهل التخصص، لإيجاد الأحكام أو الشرائع المناسبة لكل نازلة أو مستجد يقتضي تقنينا منظما أو ملزما أو مبيحا أو مانعا أو غير ذلك مما تقتضيه المصلحة المرسلة، أو الحالة الطارئة المستدعية للتقنين والتشريع.[8]
دعا الشيخ محمد الفيزازي في نفس التوجه الداعم للسلطة الرقابية للعلماء، وبلغة الوعظ المفتقرة للتدقيق الإصطلاحي القانوني إلى إخضاع “كل القوانين التي تصدر عن الجهات القانونية والحقوقية سواء في البرلمان أم في غيره، كلها يجب أن تمر عبر مصفاة الشريعة الإسلامية، وأن من له صلاحية البث في ذلك هم علماء الأمة وكبار الحقوقيين والقانونيين وأهل التخصص عامة تحت الإشراف الفعلي لأمير المؤمنين”.[9]
ومن منظور تقييم تفاعل علماء المجلس العلمي الأعلى مع المستجدات الوطنية والدولية، اعتبر الشيخ السلفي عمر الحدوشي “بأن دورهم يبقى عقيما، لأنهم لا يتكلمون في أي شيء من قضايا الأمة وآلامها، يوميا يقتل الناس في سوريا، ولم يتكلموا حين هاجم عصيد نبي الأمة صلى الله عليه وسلم”[10].
وبخلاف التصور العام للحركات الإسلامية المغربية الناظر لوظائف العلماء بنفس تربوي ونضالي على صعيد مؤسسات المجتمع والدولة، والمتحفز إلى إحياء وظيفتهم التغييرية في سبيل تحقيق النهضة الإسلامية الشاملة، ومن ضمنها تحقيق الديمقراطية السياسية. فإن الخطاب السلفي المغربي يعمل على تضخيم الدور الرقابي لعالم الدين تجاه تحولات المجتمع ومنظومة القوانين المؤطرة له وفق رؤية ماضوية لمطلب تطبيق الشريعة.
فعلى إثر مطالبة بعض الشخصيات الحقوقية والثقافية العلمانية مثل خديجة الرياضي، أحمد أمين وعبد الصمد ديالمي في صيف 2012 بإلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي المجرم للفساد من خلال إقامة علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربطهما علاقة الزوجية، لم يتفاعل السلفيون مع الطرح اللائيكي بالجدل والنقاش بالتي هي أحسن، بل دعت التنسيقية المغربية لجمعيات دور القرآن المقربة من الشيخ السلفي المراكشي المغراوي في أسلوب تحريضي “الحكومة والمجلس العلمي الأعلى والرابطة المحمدية للعلماء لتحمل مسؤوليتها في صيانة أحكام الدين الإسلامي وتفعيل مقتضيات الدستور المتعلقة بالموضوع والتحلي باليقظة والحزم في مواجهة ما وصفتهم بدعاة الفتنة”.[11]
ووفاء لهذا التوجه، ثمن كتاب صادر عن أحد السلفيين المغاربة سنة 2007 الدور الرقابي للعلماء المغاربة عبر التاريخ تجاه المجتمع خاصة في مجال محاربة البدع والتصوف استنادا لاعتقادهم بحسب الكاتب-في تعسف تاريخي جلي-للعقيدة السلفية وتبنيهم للدعوة الوهابية.[12] وهو نفس المنطلق المذهبي الذي يجعل الكثير من الأعضاء السلفيين اليوم ببلادنا يلتجئون لإشباع توجههم الديني وسلوكهم الشعائري وطلب الإفتاء من المؤسسات الدينية البرانية ومن مختلف العلماء السلفيين المشارقة، نظرا لتواضع وتقليدانية الخطاب الديني المغربي الرسمي بالمقارنة مع مقولات شيوخ وعلماء المشرق البارزين في القنوات الدينية المحسوبة على التوجه السلفي السعودي والمصري.[13]
[1] – بشكل عام يتأسس الخطاب الديني لتيار السلفية العلمية التقليدية على مفاهيم ومرتكزات أساسية منها الدفاع عن العقيدة الصحيحة والتوحيد ومناصرة السنة ومحاربة البدع التي غالبا ما يربطها شيوخ هذا التيار بالطرق الصوفية والحركات الإسلامية خاصة مع إيمان هذه الأخيرة بالمشاركة السياسية والعمل التنظيمي المعاصر ومشاركة المرأة في الشأن العام. وعلى إثر الربيع العربي سنة 2011 والحراك السياسي لحركة 20 فبراير حصلت بعض التطورات في السلوك السياسي السلفي التقليدي العربي والمغربي (الشيخ المغراوي نموذجا) في اتجاه الإيمان بالمشاركة السياسية. لكن مازالت أولويات الخطاب السلفي تتأسس على ما أسماه الراحل فريد الأنصاري باستصنام “المذهبية الحنبلية” في كتابه الأخطاء الستة للحركة الإسلامية بالمغرب. انحراف استقدام في الفكر والممارسة، مطبعة الكلمة للطبع والإشهار، الطبعة الأولى مكناس 2007. ص 116. وفي هذا الصدد كذلك نذكر عنوانا دالا عن تصور الخطاب السلفي التقليدي لمحاربة البدع. وفق المنهجية الصدامية المشهورة عند الكثير من أقلامه ودعاته، وهو: قومة المدعو ياسين الفتان بين رسالة الطوفان والخروج للعصيان (مختصر كتاب إرشاد الحائرين وتنبيه الغافلين لاجتناب ضلالات وجهالات وبغي عبد السلام ياسين) لأبي عبد الرحمن علي بن صالح الغربي. مطابع المعارف الجديدة. الطبعة الأولى الرباط 2006.
[2] – وقد برزت هاته الأدبيات بقوة في الساحة العربية بشكل عام ومنها المغرب بعد أزمة الخليج العربي الثانية في غشت من سنة 1990 على إثر استقدام النظام السعودي بقيادة الملك الراحل فهد بن عبد العزيز للقوات العسكرية الأجنبية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية للدفاع عن الأراضي السعودية تجاه تهديدات النظام العراقي السابق بزعامة الراحل صدام حسين خاصة بعد اجتياحه للكويت. ومن الكتب المشهورة في الدعوة “للجهاد” ونشر “التوحيد” ومواجهة “الطاغوت” المؤثر في أتباع التيار السلفي الجهادي بالمغرب، نذكر كتاب الشيخ الأردني الفلسطيني الأصل أبو عمر بن محمود المعروف بأبي قتادة، الجهاد والاجتهاد، تأملات في المنهج. دار البيارق الأردن، الطبعة الأولى 1419 هـ.
[3] – في هذا المضمار نورد نموذجا من الخطاب السلفي المغربي في نقده لعلماء المؤسسات الدينية الرسمية، فقد اعتبر الباحث السلفي رشيد بن أحمد بنكيران في معرض رده وتعليقه على الدرس الحسني الذي ألقاه ادريس بن الضاوية رئيس المجلس العلمي للعرائش “حول الخصوصيات الدينية في ممارسة المغاربة” لشهر رمضان 1429هـ / 2008 بأن الأخير كان في درسه “متجنيا على نصوص الوحي الشريف ومقاصد الشريعة، متخطيا بذلك أصول المذهب المالكي في الاستدلال ومنحرفا عن العقيدة السنية الصحيحة، كما وصف حجج ابن الضاوية بكونها “مخالفة للأدلة الشرعية، وتؤسس للإبقاء البدع وبعض مظاهر الشرك” وأن المحاضر أمام الملك لم يقم بواجب ميثاق العلماء الذي أخذه الله تعالى على العلماء قبل أن يأخذه عليهم الرؤساء، انظر كتاب، علماء لم ينصحوا أو وقفات مع الدرس الحسني “الخصوصيات الدينية في ممارسة المغاربة “ادريس بن الضاوية رئيس المجلس العلمي لمدينة العرائش لمؤلفه رشيد بن أحمد بنكيران. طوب بريس الرباط 2009 ص ص 7 -11.
[4] – سليم بن عبيد الهلالي السلفي، لماذا اخترت المنهج السلفي؟ دار ابن القيم. القاهرة 2009 ص 57.
[5] – أحمد بن عبد الرحمن القاضي، معالم بارزة في دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب، مجلة البيان، عدد 221 ، فبراير 2006 ص ص 56 – 59 وحول مصادر إنتاج الخطاب الديني لدى السلفية الوهابية و السلفية الجهادية المغربية انظر، سعيد اغزييل، الخطاب الديني بالمغرب، السياق العام ومصادر الإنتاج، بحث لنيل دبلوم الماستر في القانون العام المعمق. كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية. طنجة 2007 – 2008 ص ص 233 – 242.
[6] – ذو الفقار بلعويدي، العلماء الرسميون. “أي دور أية مسؤولية؟؟” جريدة السبيل العدد: 129. 13 شتنبر 2012
[7] – نفس المرجع.
[8] – محمد الفيزازي: لبنات لابد منها لبناء الدستور، منشور بالموقع الإلكتروني الرسمي للشيخ www.elfazazi.com بتاريخ 16 يونيو 2011.
[9] – نفس المرجع.
[10] حوار مع الشيخ عمر الحدوشي بجريدة أخبار اليوم عدد1089 بتاريخ14 يونيو 2013.
[11] – أيوب الطاهري، “تنسيقية دور القرآن”: دعاة الحرية الجنسية يهددون إمارة المؤمنين تقرير إخباري منشور في الموقع المغربي المختص بالحقل الديني www.islam-maghribi.com كما أن مطالب إخضاع القوانين لمرجعية الشريعة الإسلامية والتأكيد على دور العلماء في ذلك، كانت متضمنة في بيان أصدره الشيوخ السلفيين: حسن الكتاني، أبو حفص، عمر الحدوشي ومحمد الفيزازي من داخل سجنهم سنة 2005 إذ أعلنوا: “إن إسلامنا لا يمكن أن يكون واقعا ملموسا له وجود، واستقلالنا لا يكتمل إلا إذا كانت قوانيننا موافقة للشريعة الإسلامية الغراء كما كان حال المغرب إلى فجر الاستقلال، وكان هذا المطلب مرارا وتكرارا في توصيات رابطة علماء المغرب، مذكور في تقرير المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة، الحالة الدينية في المغرب 2007 – 2008 مرجع سبق ذكره ص 415.
[12] – مصطفى باحو، علماء المغرب ومقاومتهم للبدع والتصوف والقبورية والمواسيم، منشورات السبيل سلسلة بحوث في مذهب المالكية، الإصدار الثالث، يونيو 2007.
[13] – حول الدوافع السياسية والفكرية والاجتماعية لتغلغل الفكر السلفي في الحقل الديني المغربي وقطيعته الابستمولوجية مع طبائع التدين المغربي انظر، منتصر حمادة، الوهابية في المغرب، دار توبقال للنشر. الطبعة الأولى 2012. الدار البيضاء ص ص 48 – 63.